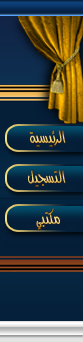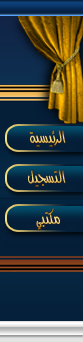الآية 10 سورة الجمعة
الآية 10 سورة الجمعة أخبر سبحانه في هذه الآية، وفي غيرها من الآيات، عن سُنَّة أقام الله
عليها الحياة، وفطرةٍ فطر الناس عليها؛ سُنَّة ماضية بمضاء الحياة، لا
تتبدل ولا تتغير؛ إنها سُنَّة التفاضل والتفاوت في الرزق، وأسباب الحياة
الأخرى المادية والمعنوية.وإذا كانت آيات أُخر قد أخبرت وأثبتت أن
الرزق بيد الله سبحانه ومن الله، فإن هذه الآية قد جاءت لتقرر أمرًا آخر،
إنه أمر التفاوت والتفاضل بين العباد، لأمر يريده الله، قد يكون ابتلاء
واختبارًا، وقد يكون غير ذلك؛ فقد تجد أعقل الناس وأجودهم رأيًا وحكمة
مقتَّرًا عليه في الرزق.
وبالمقابل تجد أجهل الناس وأقلهم تدبيرًا
موسعًا عليه في الرزق؛ وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهرًا عليه،
فالمقتَّر عليه لا يدري أسباب التقتير في رزقه، والموسَّع عليه لا يدري
أسباب التيسير، ذلك لأن الأسباب كثيرة ومترابطة ومتوغِّلة في الخفاء، حتى
يُظن أن أسباب الأمرين مفقودة وما هي كذلك، ولكنها غير محاط بها.
كتب
عمر رضي الله عنه رسالة إلى أبي موسى الأشعري، يقول له فيها: واقنع برزقك
من الدنيا، فإن الرحمن فضَّل بعض عباده على بعض في الرزق، بلاء يبتلي به
كلاً، فيبتلي من بسط له، كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما
رزقه وخوله، رواه ابن أبي حاتم.
قال الشوكاني عند تفسير هذه الآية:
"فجعلكم متفاوتين فيه - أي الرزق - فوسَّع على بعض عباده، حتى جعل له من
الرزق ما يكفي ألوفًا مؤلَّفة من بني آدم، وضيَّقه على بعض عباده، حتى صار
لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم، وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول
العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابها، وكما جعل التفاوت بين عباده
في المال، جعله بينهم في العقل والعلم والفهم، وقوة البدن وضعفه، والحسن
والقبح، والصحة والسقم، وغير ذلك من الأحوال".
وعلى هذا فمعنى الآية:
أن الله سبحانه - لا غيره - بيده رزق عباده، وإليه يرجع الأمر في تفضيل
بعض العباد على بعض، ولا يسع العبد إلا الإقرار بذلك، والتسليم لما قدره
الله لعباده، من غير أن يعني ذلك عدم السعي وطلب الرزق والأخذ بالأسباب..
فهذا
غير مراد من الآية ولا يُفهم منها، ناهيك عن أن هذا الفهم يصادم نصوصًا
أُخر تدعوا العباد إلى طلب أسباب الرزق، وتحثهم على السعي في تحصيله، قال
تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِن فَضْلِ اللَّهِ}... (الجمعة : 10)، وفي الحديث: (اعملوا فكل ميسر لما
خُلق له) متفق عليه، والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
على أنه من المفيد
هنا التنبيه إلى أن التفاضل الذي أقامه سبحانه بين عباده ليس محصورًا ولا
مقصورًا على التفاضل المادي، من مال ومنافع فحسب، بل هو أشمل من ذلك وأعم،
إذ يدخل فيه التفاضل في العلم والعقل، والقوة والضعف، وغير ذلك مما هو
مشاهد في حياة الناس.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الموقف الرشيد
والسديد من هذه السُّنَّة الكونية القناعة بما قسم الله ورزق، مع الأخذ
بالأسباب لتحصيل كل ما هو مطلوب ومباح شرعًا، فالأمر منظور إليه من طرفين،
طرف الرضى والقبول والاستسلام لأمر الله وقضائه، وطرف العمل والسعي المطلوب
شرعًا.
أما الاستسلام السلبي الذي يشل حركة الإنسان، ويدفع به إلى
القعود والتراكن والخنوع، فليس هو الموقف الصحيح والرشيد، بل هو موقف قاصر
وناظر إلى طرف واحد من أطراف المعادلة، غافل عن نظر آخر لابد من اعتباره
والسعي على وَفْقِه، فشتان بين الموقفين.
ثم إن هذه الآية على صلة
وارتباط بآية أخرى في سورة النساء، وهي قوله تعالى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْا
مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}... (النساء:32) وسبب
نزول هذه الآية - فيما رويَ - أن أمَّ سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول
الله، تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت: {وَلاَ
تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} رواه
الترمذي.
قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله، وأَمَر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله.
وقال
الطبري في معنى الآية: ولا تتمنوا - أيها الرجال والنساء - الذي فضل الله
به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير، وليرضَ أحدكم بما قسم الله
له من نصيب، ولكن سلوا الله من فضله.
واعلم - أيها القارئ الكريم -
أنه بسبب جهل بعض الناس بهذه السُّنَّة الكونية، دخل عليهم من الحسد
والبلاء ما لا يحيط به قول ولا وصف، ولو قَنَع الناس بهذه السُّنَّة
واستحضروها في تعاملهم ومعاملاتهم لكان أمر الحياة أمرًا آخر.
أمَا
وقد أعرض البعض عن فطرة خالقهم، ولم يسلموا ويستسلموا لِمَا أقامهم عليه،
فقد عاشوا معيشة ضنكًا، وخسروا الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله الكريم أن
يرزقنا القناعة والرشاد والسداد في الأمر كله.