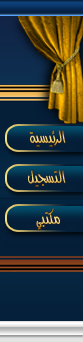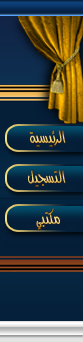من
العادات التي تعارف عليها الناس عبر العصور والأيام، أن الذين يحكم
عليهم بالإعدام، يعلق على صدورهم ما يشير إلى جريمتهم التي ارتكبوها
واقترفوها؛ ليتعظ الناس بذلك، ويرعووا عن الإقدام على مثل فعلهم.
وقد صور لنا القرآن الكريم مشهداً من مشاهد يوم القيامة قريباً من المشهد الذي صدَّرنا به الحديث، حيث قال تعالى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا}
(الإسراء:13). فما هو المراد من (الطائر)، وما هو المراد من (الكتاب
المنشور)، وما هو المعنى العام لهذه الآية؟ هذا ما نعرفه في الفقرات
التالية:
الطائر
يذكر المفسرون قولين في المراد بـ (الطائر) في هذه الآية ونحوها من الآيات:
القول الأول: أن العرب إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال، وأرادوا أن
يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر، اعتبروا أحوال الطير، وهو
أنه يطير بنفسه، أو يحتاج إلى إثارته، وإذا طار فهل يطير متيامناً أو
متياسراً، أو صاعداً إلى الجو إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا
يعتبرونها. ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة
والشقاوة. فلما كثر ذلك منهم، سمي الخير والشر بـ (الطائر) تسمية للشيء
باسم لازمه. ونظيره قوله تعالى: {قالوا إنا تطيرنا بكم} (يس:18) إلى قوله: {قالوا طائركم معكم} (يس:19)، فقوله: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه}، معناه بحسب هذا القول: كل إنسان ألزمناه عمله في عنقه. قال ابن كثير هنا: "المقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه، قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلاً ونهاراً، صباحاً ومساءً".
القول الثاني: (الطائر) عند العرب (الحظ)، وهو الذي تسميه الفُرْس (البخت)،
وعلى هذا يجوز أن يكون معنى (الطائر) ما طار له من خير وشر؛ إذ التحقيق
في هذا الباب، أنه تعالى خلق الخلق، وخص كل واحد منهم بمقدار مخصوص من
العقل والعلم، والعمر والرزق، والسعادة والشقاوة. والإنسان لا يمكنه أن
يتجاوز ذلك القدر، وأن ينحرف عنه، بل لا بد وأن يصل إلى ذلك القدر بحسب
الكمية والكيفية، فتلك الأشياء المقدورة له، كأنها تطير إليه، وتصير إليه؛
فبهذا المعنى، لا يبعد أن يُعبَّر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ
(الطائر)، ويكون قوله: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى، ومضى في علمه حصوله، فهو لازم له، واصل إليه غير منحرف عنه.
قال الأزهري: الأصل في هذا، أن الله سبحانه
لما خلق آدم، علم المطيع من ذريته والعاصي، فكتب ما علمه منهم أجمعين،
وقضى سعادة من علمه مطيعاً، وشقاوة من علمه عاصياً، فطار لكل منهم ما هو
صائر إليه عند خلقه وإنشائه؛ وذلك قوله: {ألزمناه}.
وبعد أن ذكر الشيخ الشنقيطي حاصل هذين
القولين، قال: "والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول
إليه من الشقاوة أو السعادة". ثم استدل لكلا القولين بآيات من القرآن؛
أما القول الأول -وهو كون المراد بـ (الطائر) عمل الإنسان- فاستدل له
بالآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جداً، كقوله تعالى: {من يعمل سوءا يجز به}
(النساء:123). وأما القول الثاني -وهو كون المراد بـ (الطائر) نصيبه
الذي طار له في الأزل من الشقاوة أو السعادة-، فاستدل له بالآيات الدالة
على ذلك أيضاً، كقوله سبحانه: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} (التغابن:2).
وعلى الجملة، فالمراد من قوله سبحانه: {ألزمناه طائره في عنقه}، كما قال ابن عاشور:
أن كل إنسان يعامل بعمله من خير أو شر، لا يُنقص له منه شيء. أو كما قال
السعدي: ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازماً له، لا يتعداه إلى غيره،
فلا يحاسب بعمل غيره، ولا يحاسب غيره بعمله.
الكتاب المنشور
المراد بـ (الكتاب المنشور)، الكتاب الذي دُوِّنت فيه أعمال العبد، صغيرها
وكبيرها، خيرها وشرها، حسنها وسيئها. قال ابن كثير: "نجمع له عمله كله في
كتاب، يُعطاه يوم القيامة، إما بيمينه، إن كان سعيداً، أو بشماله إن كان
شقياً". وقوله: {منشورا} أي: مفتوحاً، يقرؤه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، على حد قوله سبحانه: {ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر}
(القيامة:13). فـ (النشر) في الآية -كما قال ابن عاشور- كناية عن سرعة
اطلاعه على جميع ما عمله، بحيث إن الكتاب يحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحاً
للمطالعة. ونشر الكتاب إظهاره ليقرأ، قال تعالى: {وإذا الصحف نشرت} (التكوير:10).
وقفات مع الآية
الأولى: قوله سبحانه: {ألزمناه طائره في عنقه}، قال الرازي:
(العنق) كناية عن اللزوم، كما يقال: جعلت هذا في عنقك، أي: قلدتك هذا
العمل، وألزمتك الاحتفاظ به، ويقال: قلدتك كذا، وطوقتك كذا، أي: صرفته
إليك، وألزمته إياك، ومنه قلده السلطان كذا، أي: صارت الولاية في لزومها له
في موضع القلادة، ومكان الطوق، ومنه يقال: فلان يقلد فلاناً، أي، جعل
ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عنقه.
قال أهل العلم: وإنما خص (العنق) من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى؛ لأن
الذي يكون عليه: إما أن يكون خيراً يزينه، أو شراً يشينه، وما يزين يكون
كالطوق والحلي، والذي يشين فهو كالغل والقيد، فههنا عمله إن كان من الخيرات
كان زينة له، وإن كان من المعاصي كان كالغل على رقبته.
وقال ابن كثير: إنما ذكر (العنق)؛ لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه، فلا محيد له عنه.
الثانية: قال بعض أهل العلم المتقدمين: هذه الآية من أقوى الأدلة على أن كل
ما قدره الله تعالى للإنسان، وحكم عليه به في سابق علمه، فهو واجب
الوقوع، ممتنع العدم. فكل ما كتبه سبحانه على الإنسان واقع لا يتأخر، ولا
يتخلف. ولا يلزم عن هذا أن يكون الإنسان مجبوراً على عمله، بل ما عمله
الإنسان من كسب يده، وإنما هو سابق علم الله في هذا العبد.
الثالثة: قال بعض الصلحاء: هذا كتاب، لسانك قلمه، وريقك مداده، وأعضاؤك
قرطاسه، أنت كنت المملي على حفظتك، ما زيد فيه ولا نقص منه، ومتى أنكرت منه
شيئاً، يكون فيه الشاهد منك عليك